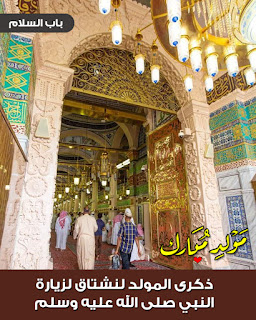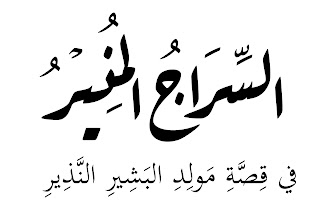الأربعاء، 7 نوفمبر 2018
نفحات موسم المولد
نفحات موسم المولد:
الأزمان تتبارك بالأحداث المباركة التي تقضى فيها الشؤون الإلهية العظيمة، والبركة تتجدد كلما عادت الذكرى، وهذا جلي في خصوصية يوم الجمعة ففيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. وفي ذكرى فداء سيدنا إسماعيل عليه السلام، وفي ذكرى عاشوراء، وغير ذلك، وفي قوله تعالى: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ) منبهًا ليس فقط على اللحظة أو الساعة أو اليوم، بل على الشهر الذي أنزل فيه القرآن العظيم.
لذلك يستحب التعرض لنفحات تلك البركات متى ما عُلم زمانها وحلَّ موسمها وأوانها، وليس في ذلك شبهة للبدعة بأي وجه من الوجوه لأن البدعة نوعان: بدعة لغوية وبدعة شرعية، أما البدعة الشرعية فجمهور أهل العلم من كل المذاهب سلفًا وخلفًا أجمعوا على أنها كل عمل محدث ليس له أصل في الدين، أي ليس عليه دليل خاص أي صريح، أو دليل عام أي بالقياس وبالنصوص العامة كقوله تعالى: (وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)، (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ)، ونظائرها. أما ما كان له أصل في الدين بطريق خاص أو عام فإنه بدعة لغوية فقط وليس شرعية، كالصلاة مثلًا، فالصلاة لغة هي الدعاء، أما شرعًا فهي الصلاة الشعيرة، هذا ملخص جمهور أهل العلم لكل النصوص الشرعية التي تناولت البدعة.
الاحتفال لغةً من الحفل، أي الاهتمام والاكتراث والعناية، واحتفل بالميلاد بمعنى حفل به واهتم واعتنى ولفت النظر إليه، وأول من احتفل بميلاد الأنبياء هو الله تعالى كما قال عن يحيى عليه السلام: (وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا)، وعلى لسان عيسى عليه السلام: (وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا)، فميلاد الأنبياء من الأحداث العظيمة التي لفت الله تعالى النظر إليها في القرآن الكريم، على أن الاحتفال بالميلاد يكون بالشكر على النعمة وإظهار السرور والفرح لذلك شرعت العقيقة (السماية)، بينما في الوفاة يكون بالصبر والاعتبار.
وأول من احتفل بذكرى المولد النبوي الشريف هو رسول الله ﷺ، وكان ذلك بعد أن هاجر إلى المدينة المنورة، أي بعد ميلاده الشريف بنحو ثلاث وخمسين سنة، فنبَّه الأمة ولفت نظرها إلى نعمة ميلاده الشريف بأنه كان يداوم على صيام اليوم الذي ولد فيه، ودعا الصحابة وذبح العقيقة (السماية) وهو في هذا العمر العظيم، وكان يحدثهم بما أخبرته به أمه السيدة آمنة عن ميلاده الشريف، وأنه لما ولد خرج معه نور أضاء مشارق الأرض ومغاربها.
وجود النبي ﷺ بين الصحابة كان احتفالًا دائمًا به لأنه كان أغلى شيء في حياتهم، وسار على ذلك التابعون وتابعوهم إلى أن مرت القرون وتطاول الأمد بالناس وغشيهم شيء من الغفلة عن رسول الله ﷺ فبرزت الحاجة إلى التذكير والتنبيه ولفت النظر مرة أخرى، وأول من أحيا سنة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في الثاني عشر من شهر ربيع الأول على المشهور عند الجمهور -كما قرره الإمام ابن كثير- هو الملك المظفر صاحب إربل. قال الإمام الحافظ السيوطي في [حسن المقصد]: "وأول من أحدث فعل ذلك صاحب إربل الملك المظفر أبو سعيد كوكبري بن زين الدّين علي بن بكتكين أحد الملوك الأمجاد والكبراء الأجواد"، والملك المظفر كان متواضعًا، خيرًا، سُنِّيًّا، يحب الفقهاء والمحدثين كما قال الإمام الذهبي، فليس لاحتفالنا بالمولد على هذا التأصيل علاقة بالروافض أو الدولة الفاطمية أو تشبه بالنصارى.
وقد قرر جمهور أهل العلم من كافة المذاهب وكذلك دور الفتوى في العالم الإسلامي مشروعية الاحتفال بالمولد، وهذا مستند شرعي متين يحمي المحتفلين من اعتراض المعترضين، فمن الأئمة الذين قرروا مشروعيته الإمام الإمام الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية، والإمام الحافظ أبو العباس العَزَفي، والإمام الحافظ أبو شامة المقدسي، والإمام الحافظ عبد الرحيم العراقي، وإمام القراء الحافظ شمس الدين ابن الجزري، والإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني، والإمام الحافظ شمس الدين السخاوي، والإمام الحافظ جلال الدين السيوطي، والإمام المحدث الفقيه ابن حجر الهيتمي، والإمام المحدث الفقيه ملا علي قاري، الإمام المحدث الفقيه محمد عبد الرؤوف المناوي، وغيرهم.
المولد مهم ويزداد أهمية كلما زادت غفلة الأجيال برسول الله ﷺ، فلا ينبغي أن تفوتك فرصة التعرض لهذه النفحات العظيمة، ولا تكدر صفوها بأي فعل قبيح لا يشبه هذه الذكرى العطرة.
الثلاثاء، 6 نوفمبر 2018
ترجمة الإمام الحافظ ابن دحية الكلبي
قدم له الذهبي بقوله: "الشيخ العلامة المحدث الرحال المتفنن مجد الدين أبو الخطاب"، ونقل عن الإمام أبي عبد الله الأبار قوله: "وكان بصيرا بالحديث معتنيا بتقييده، مكبا على سماعه، حسن الخط، معروفا بالضبط، له حظ وافر من اللغة ومشاركة في العربية وغيرها" وفي هذا شهادة عظيمة من من إمام حافظ ومؤرخ بصير بالرجال، فإن أبا عبد الله الأبار ممن عاصر الحافظ ابن دحية ومن المتمكنين في معرفة الرجال، فقد ترجم الذهبي للأبار بقوله: "كان بصيرًا بالرجال المتأخرين، مؤرخًا، حلو التترجم، فصيح العبارة، وافر الحشمة، ظاهر التجمل، من بلغاء الكتبة، وله تصانيف جمة منها "تكملة الصلة" في ثلاثة أسفار اخترت منها نفائس".
وترجم له الإمام الحافظ السيوطي في [بغية الوعاة] فقال:
"ابن دحية الكلبي عمر بن الحسن بن علي بن محمّد بن الجميل بن فرح بن دحية الكلبي الأندلسي البلنسي الحافظ، أبو الخطّاب، كان من أعيان العلماء ومشاهير الفضلاء، متقناً لعلم الحديث وما يتعلّق به، عارفاً بالنحو واللغة وأيّام العرب وأشعارها، سمع الحديث ورحل، وله بنى الكامل دار الحديث الكامليّة بالقاهرة، وجعله شيخاً، حدث عنه ابن الصلاح وغيره"
وترجم له في [حسن المحاضرة] فقال:
"ابن دحية الكلبي ابن دحية، الإمام العلامة الحافظ الكبير، أبو الخطاب، عمر بن الحسن الأندلسي البلنسي، كان بصيراً بالحديث متقناً به، له حظّ وافر من اللغة ومشاركة في العربية، له تصانيف، توطن مصر وأدب الملك الكامل، ودرس بدار الحديث الكاملية"
فكيف بإمام حافظ كبير كان شيخًا للإمام الحافظ ابن الصلاح المشهور بالنقد وطول الباع في علم الحديث؟!
وقد ذكر الذهبي في ترجمة الملك المظهر حبه للفقهاء والمحدثين وما صنفه الإمام الحافظ ابن دحية من كتاب المولد وإجازة الملك عليه فقال:
"وأما احتفاله بالمولد، فيقصر التعبير عنه؛ كان الخلق يقصدونه من العراق والجزيرة، وتنصب قباب خشب له ولأمرائه وتزين، وفيها جوق المغاني واللعب، وينزل كل يوم العصر، فيقف على كل قبة ويتفرج، ويعمل ذلك أيامًا، ويخرج من البقر والإبل والغنم شيئا كثيرًا، فتنحر، وتطبخ الألوان، ويعمل عدة خلع للصوفية، ويتكلم الوعاظ في الميدان، فينفق أموالا جزيلة. وقد جمع له ابن دحية -الحافظ [كتاب المولد]، فأعطاه ألف دينار. وكان متواضعًا، خيرًا، سُنِّيًّا، يحب الفقهاء والمحدثين" انتهى
وكذا ابن كثير في ترجمة الملك المظفر في "البداية والنهاية":
"أحد الأجواد، والسادات الكبراء والملوك الأمجاد، له آثار حسنة، وقد عمر الجامع المظفري بسفح قاسيون..
وكان يعمل المولد الشريف في ربيع الأول ويحتفل به احتفالًا هائلًا، وكان مع ذلك شهمًا شجاعًا فاتكًا بطلًا عاقلًا عالمًا عادلًا رحمه الله وأكرم مثواه. وقد صنَّف الشيخ أبو الخطاب ابن دحية له مجلدًا في المولد النبوي سماه [التنوير في مولد البشير النذير]، فأجازه على ذلك بألف دينار" انتهى
وكذا الإمام الحافظ ابن خلكان في ترجمة الحافظ ابن دحية: "كان من أعيان العلماء ومشاهير الفضلاء، قدم من المغرب فدخل الشام والعراق، واجتاز بإربل سنة أربع وستمائة فوجد ملكها المعظم مظفر الدين بن زين الدين يعتني بالمولد النبوي، فعمل له كتاب [التنوير في مولد البشير النذير]، وقرأه عليه بنفسه فأجازه بألف دينار".ا.هـ.
الجمعة، 2 نوفمبر 2018
الشوكاني ينبه على أن عقيدة الوهابية في الإمرار هي عقيدة مشبهة
قال رحمه الله تعالى في إرشاد الفحول (صـ229)
(الفصل الثاني فيما يدخله التأويل وهو قسمان:
أحدهما أغلب الفروع، ولا خلاف في ذلك.
والثاني الأصول كالعقائد وأصول الديانات وصفات الباري عز وجل، وقد اختلفوا في هذا القسم على ثلاثة مذاهب:
■ الأول: أنه لا مدخل للتأويل فيها بل يجري على ظاهرها ولا يؤول شيء منها وهذا قول المشبهة.
■ والثاني: أن لها تأويلا ولكنا نمسك عنه مع تنزيه اعتقادنا عن التشبيه والتعطيل لقوله تعالى: { وما يعلم تأويله إلا الله}، قال ابن برهان وهذا قول السلف.
قلت: وهذا هو الطريقة الواضحة والمنهج المصحوب بالسلامة عن الوقوع في مهاوي التأويل لما لا يعلم تأويله إلا الله، وكفى بالسلف الصالح قدوة لمن أراد الاقتداء وأسوة لمن أحب التأسي، على تقدير عدم ورود الدليل القاضي بالمنع من ذلك فكيف وهو قائم موجود في الكتاب والسنة.
■ والمذهب الثالث: أنها مؤولة، قال ابن برهان: والأول من هذه المذاهب باطل، والآخران منقولان عن الصحابة، ونقل هذا المذهب الثالث عن علي وابن مسعود وابن عباس وأم سلمة). انتهى
في بطلان إنكار ابن تيمية وابن القيم وقوع المجاز في اللغة العربية والقرءان الكريم والسنة المطهرة
اتفق جمهور أهل العلم على أنَّ المجاز واقع في اللغة وفي القرآن الكريم، وفي سنة النبي – عليه أفضل الصلاة والسلام –، وقد قال به علماء كُثر في مختلف تخصصاتهم وتعدد الفنون التي برعوا فيها، منهم اللغويون والنحويون والمفسرون والمحدثون والأصوليون والأدباء والنقاد وأهل المنطق وعلماء البلاغة، وتداولته ألسنة وأقلام الكتاب قديماً وحديثاً، واستعملته العرب خلفاً عن سلف.
وكان الفضل في اتساع البحث في المجاز يرجع إلى اللغويين والنحاة والأدباء والنقاد والاعجازيين أما مسائله وقضاياه ودقائقه فلم يحرر القول فيها إلا في مباحث البلاغيين بدءاً من الإمام عبدالقاهر الجرجاني إلى الخطيب القزويني ومن كان بينهما.
قال الإمام عبد القاهر الجرجاني في كتابه "أسرار البلاغة" : "ومن قدح في المجاز، وهمَّ أن يصفه بغير الصدق فقد خبط خبطاً عظيماً، وتهدف لما لا يخفى". أهـ
قال الإمام الشوكاني في كتابه "إرشاد الفحول": "المجاز واقع في لغة العرب عند جمهور أهل العلم وخالف في ذلك أبو إسحاق الإسفراييني وخلافه هذا يدل أبلغ دلالة على عدم اطلاعه على لغة العرب. وينادي بأعلى صوت، بأن سبب هذا الخلاف تفريطه في الاطلاع على ما ينبغي الاطلاع عليه من هذه اللغة الشريفة، وما اشتملت عليه من الحقائق والمجازات التي لا تخفى على من له أدنى معرفة بها، وقد استدل بما هو أوهن من خيوط العنكبوت فقال: لو كان المجاز واقعاً في لغة العرب للزم الإخلال بالتفاهم إذ قد تخفى القرينة. وهذا التعليل عليل فإن تجويز خفاء القرينة أخفى من السها " انتهى.
وإنكار المجاز –بعد التحقيق– لا يكاد يوجد، لأن من قال بإنكاره في القرآن لم يمنع وقوعه في اللغة، وثلاثة من العلماء أنكروه مطلقًا وهم الإمام أبواسحق الاسفرائيني وابن تيمية وابن القيم الجوزية، وهم وإن أنكروه من جهة فقد أقرّوا به من جهات في كثير من كلامهم ولهذا يقال: "إنَّ إنكار المجاز لا يكاد يوجد".
ولكن في الحقيقة أن أبا إسحاق الإسفرائيني ثبت أنه لم ينكر المجاز، ونسبة إنكار المجاز إليه وإن ورد ذكرها في كثير من كتب الأصول وغيرها فإنها لم تسلم من القدح والتشكيك، فقد تعقب بعض العلماء هذه النسبة واستبعدوا صدورها من أبي إسحاق منهم إمام الحرمين أبو المعالي وحجة الإسلام الغزالي، ويؤيد رأي هؤلاء العلماء ذلك النص الذي حكاه ابن القيم عن الأستاذ في مسألة: "العام إذا خصص هل يكون حقيقة فيما بقي أم مجازاً؟" وفيه إعتراف صريح من الأستاذ الإسفرائيني بالمجاز، ونقل عنه إمام الحرمين أبو المعالي نصاً آخر في "البرهان" حول مسألة أصولية كذلك وهي: "ما المراد بالظاهر عند علماء الأصول؟" وفي ذلك يقول إمام الحرمين: "وقال الأستاذ أبو إسحق: الظاهر لفظ معقول يبتدر إلى فهم البصير بجهة الفهم منه معنى، وله عنده وجه التأويل مسوغ، لا يبتدره الظن والفهم، ويخرج على هذا ما يظهر في جهة الحقيقة ويؤول في جهة المجاز"، فهذا كلام من يقر بالمجاز لا من ينكره، فلم يبق منكرًا له مطلقًا إلا ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.
ومن أشهر الأمثلة على المجاز في القرءان الكريم قوله تعالى: (وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا) [الإسراء: 72]، فإن العمى في الدنيا لا يقتضي العمى في الآخر، ورحم الله سيدنا عبد الله بن أم مكتوم، الصحابي الكبير، فقد كان أعمى.
في إبطال الإحتجاج بأن الأمة تعود للشرك مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم: (والله إني لا أخاف عليكم الشرك من بعدي)
أما قوله تعالى: (وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ) [سورة يوسف: 106]
فإنه معطوف على ما قبله وهو قوله تعالى: (وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ * وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ * وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ) وهو صريح في أنهم كفارًا غير مؤمنين لكونهم معرضين عن آيات الله في السماوات والأرض، وصريح في أنهم مشركون نسبوا لله الند: (إلا وهم مشركون)، لم يكونوا مسلمين أو مؤمنين ثم أشركوا.
وهي صريحة في من يعبدون مع الله إله آخر، يؤمنون بالله ويؤمنون بغيره، مثل من عبدوا عيسى وعزيرا عليهما السلام. ويدخل فيها كل من يجعل لله شريكا.
قال الطبري في تفسيره: "(إلا وهم مشركون) في عبادتهم الأوثان والأصنام, واتخاذهم من دونه أربابًا, وزعمهم أنَّ له ولدًا, تعالى الله عما يقولون".
عن الحسن: "أنهم أهل كتاب معهم شرك وإيمان، آمنوا بالله وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم؛ فلا يصح إيمانهم" حكاه ابن الأنباري.
وعن الحسن: "نزلت في المنافقين؛ المعنى: وما يؤمن أكثرهم بالله أي باللسان إلا وهو كافر بقلبه" ذكره الماوردي.
أما ما يروى من أنه في آخر الزمان يرجع حي من هذه الأمة إلى الشرك وعبادة الأصنام كقوله صلى الله عليه وسلم: "حتي تلحق قبائل من امتي بالمشركين" يعني بأمتي أمة الدعوة لأن ذلك الذي ذكره يحصل قبيل قيام الساعة، وبعد أن تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا الكفار وشرار الخلق. قال الحافظ في الفتح:
"ولمسلم وأحمد من حديث ثوبان ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان ولمسلم أيضا عن عائشة لا تذهب الأيام والليالي حتى تعبد اللات والعزى من دون الله الحديث وفيه ثم يبعث الله ريحا طيبة فيتوفى بها كل مؤمن في قلبه مثقال حبة من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم وفي حديث حذيفة بن أسيد شاهده وفيه أن ذلك بعد موت عيسى بن مريم قال البيهقي وغيره الأشراط منها صغار وقد مضى أكثرها ومنها كبار ستأتي قلت وهي التي تضمنها حديث حذيفة بن أسيد عند مسلم وهي الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها كالحامل المتم ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج والريح التي تهب بعد موت عيسى فتقبض أرواح المؤمنين وقد استشكلوا على ذلك حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله فإن ظاهر الأول أنه لا يبقى أحد من المؤمنين فضلا عن القائم بالحق وظاهر الثاني البقاء ويمكن أن يكون المراد بقوله أمر الله هبوب تلك الريح فيكون الظهور قبل هبوبها فبهذا الجمع يزول الإشكال بتوفيق الله تعالى فأما بعد هبوبها فلا يبقى إلا الشرار وليس فيهم مؤمن فعليهم تقوم الساعة"
وقال في موضع آخر:
"للطبراني من وجه آخر عنه لا تقوم الساعة على مؤمن ولأحمد بسند جيد عن عبد الله بن عمر لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض فيبقى عجاج لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا وللطيالسي عن أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى يرجع ناس من أمتي إلى الأوثان يعبدونها من دون الله وقد تقدم حديثه في ذكر ذي الخلصة قريبا ولابن ماجه من حديث حذيفة ويبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها ولمسلم وأحمد من حديث ثوبان ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان ولمسلم أيضا عن عائشة لا تذهب الأيام والليالي حتى تعبد اللات والعزى من دون الله الحديث وفيه ثم يبعث الله ريحا طيبة فيتوفى بها كل مؤمن في قلبه مثقال حبة من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم وفي حديث حذيفة بن أسيد شاهده وفيه أن ذلك بعد موت عيسى بن مريم قال البيهقي وغيره الأشراط منها صغار وقد مضى"
فالحديث صريح في أن دين الإسلام مستمر تام ولا يقع المسلمون في الشرك إلى آخر الزمان.
وفي ذكر الدجال وصفته وما معه أخرج الإمام مسلم في صحيحه حديثًا طويلًا في أشراط الساعة عن النواس بن سمعان رضي الله عنه مرفوعًا جاء فيه: "فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ" إلى أن قال: " ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة، فتأخذهم تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة "
وهذا صريح في بيان متى تكون تلك الريح.
عروراء أهل الأحوال
قال سيدنا سلمان رضي الله عنه وأرضاه:
"مكثت بعمورية ما شاء الله ان أمكث، ثم مر بي نفر من كلب تجار فقلت لهم: أحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه، قالوا: نعم، فأعطيتهموها وحملوني معهم حتى إذا بلغوا وادي القرى ظلموني فباعوني من رجل يهودي عبدا،ً فكنت عنده ورأيت النخل، فرجوت أن يكون البلد الذي وصف لي صاحبي ولم يحق في نفسي. فبينا أنا عنده إذ قدم عليه بن عم له من بني قريظة من المدينة فابتاعني منه، فاحتملني إلى المدنية، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي فأقمت بها، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام بمكة ما أقام لا اسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق، ثم هاجر إلى المدينة فوالله إني لفي رأس عذق لسيدي أعمل له فيه بعض العمل وسيدي جالس تحتي إذ أقبل بن عم له حتى وقف عليه فقال؛ يا فلان قاتل الله بني قيلة والله إنهم الآن لمجتعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي.
قال: "فلما سمعتها أخذني العروراء"
قال ابن هشام: "العروراء الرعدة من البرد والانتفاض، فإن كان مع ذلك عرق فهي الرحضاء وكلاهما ممدود"
ثم تابع سيدنا سلمان رضي الله عنه وأرضاه كلامه: "حتى ظننت أني سأسقط على سيدي، فنزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه ذلك: ماذا تقول؟ فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة؛ ثم قال: ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك. قال قلت: لا شيء، إنما أردت أن أستثبته عما قال."
[سيرة ابن هشام]
تأخير الصلاة أو جمعها لدرس العلم أو لحاجة معتبرة شرعًا
أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر"
وفي رواية: "جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر"، قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: "كي لا يحرج أمته"
وروى مسلم أيضًا عن عبد الله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس -رضي الله عنهما- يومًا بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون: "الصلاة الصلاة". قال: فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني "الصلاة الصلاة"، فقال ابن عباس -رضي الله عنهما: "أتعلمني بالسُّنة؟" ثم قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء". قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة فسألته، فصدق مقالته.
التحذير من التكفير والتشريك
لا يعتبر العمل عبادة لله، أو لغير الله إلا بالنية:
فالنية هي أساس كل عمل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات)، ولولا النية لما كان هناك فرق بين من يعبدون الأصنام وبين من يصلون إلى الكعبة المشرفة، فكلاهما أحجار، بيد أن الكفار يعبدون أحجارهم من دون الله، والمسلمون يتخذون الكعبة قبلة واتجاهًا يعبدون فيه الله عز وجل الواحد الأحد، المنزه عن الجهة والحد.
لذلك فليحذر الذين يحكمون على عقائد الناس من ظاهر الأعمال، فإنهم على خطر عظيم، فإنك إن رميت أحد المسلمين بالكفر أو الشرك بظن ووهم فإنهما يرتدان إليك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما رجل قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما. إن كان كما قال؛ وإلا رجعت عليه) [متفق عليه].
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن ما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رُئيت بهجته عليه وكان ردئاً للإسلام، غيَّره إلى ما شاء الله فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره، وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال: قلت: يا نبي الله أيهما أولى بالشرك المرمي أم الرامي؟ قال: بل الرامي).
[أخرجه ابن حبان في صحيحه، والبزار وحسنه، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: إسناده حسن].
فما حاجتك إلى ذلك؟؟؟ هذه مجازفة عظيمة! إن الحساب يوم القيامة فردي يوم ولن يغني عنك في الباطل غيرك وكما قال تعالى: (وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ * رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا)
إن الإسلام هو أن تشهد الشهادتين وتقيم أركان الدين، قال جبريل عليه السلام: "يا محمد أخبرني عن الإسلام" ، فقال له: (الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلًا)، قال: "صدقت" [متفق عليه]
والكفر بالله لا يكون إلا باعتراف الكافر: (قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنتُم بِهِ كَافِرُونَ)، والشرك بالله لا يكون إلا باعتراف المشرك: (قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ)، لذلك تجد ملاحدة اليوم يجهرون بكفرهم، وعباد البقر والأصنام يجهرون بشركهم، وعباد الأب والإبن والروح القدس يعترفون بعبادتهم: (مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ)، ومن صدرت منه أقوالا أو أفعالا كفرية فإن أمره يرفع للقضاء الشرعي المتخصص للاستتابة ورفع الجهل، فإن تاب فذا وإلا قتل حد الردة، أما أن تدعي أنت على مسلم بأنه كافر أو أنه مشرك فقط لأنك تتوهم أمورًا على غير حقيقتها فلا ثم لا، لأنك لست الجهة الشرعية الرسمية المخولة بذلك، والاستتابة الشرعية لها شروطها وضوابطها، أما أن يكون التكفير والتشريك فوضى يخوض فيه حتى عوام الناس فهذه فتنة وضلال.
إن الله لم يتعبد أحدًا بتفتيش نوايا الناس والحكم على إيمانهم وكفرهم من ظاهر أعمالهم، فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: (بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحُرَقَةِ من جُهَيْنَةَ، قال: فصبَّحنا القوم فهزمناهم، قال: ولحقتُ أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم، قال: فلما غشيناه قال: "لا إله إلا الله"، قال: فكفَّ عنه الأنصاري، فطعنته برمحي حتى قتلته، قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقال لي: "يا أسامة، أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟" قال: قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذاً، قال: "أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟" قال: فما زال يكررها علي، حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم). [أخرجه البخاري ومسلم]
وفي رواية الأعمش: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا.
إن المنافقين كانوا يظهرون الإسلام ويضمرون الكفر وقد أطلع الله عز وجل نبيه على حالهم ومع ذلك لم يفضحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما التوسع في التكفير والتشريك والتبديع الذين يقع فيه عوام الناس اليوم وأدعياء العلم فليس من الإسلام في شيء.
من هو المحدِّث؟
قال الإمام الحافظ تاج الدين السبكي (ت 771 هـ) رحمه الله في كتابه (معيد النعم) فيما نقله الإمام السيوطي في التدريب ص6 قال رحمه الله:
(من الناس فرقة ادعت الحديث، فكان قصارى أمرها النظر في مشارق الأنوار للصاغاني، فإن ترفعت فإلى مصابيح البغوي، وظنت أنها بهذا القدر تصل إلى درجة المحدثين!! وماذلك إلا بجهلها بالحديث، فلو حفظ من ذكرناه هذين الكتابين عن ظهر قلب، وضم إليهما من المتون مثليهما: لم يكن محدثاً، ولايصير بذلك محدثاً حتى يلج الجمل في سم الخياط!!!!
فإن رامت بلوغ الغاية في الحديث -على زعمها- اشتغلت بجامع الأصول لابن الأثير، فإن ضمت إليه كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، أو مختصره المسمى بالتقريب للنووي، ونحو ذلك، وحينئذ ينادى إلى من انتهى إلى هذا المقام: محدث المحدثين، وبخاري العصر! وماناسب هذا الألفاظ الكاذبة، فإن من ذكرناه لا يعد محدثاً بهذا القدر.
إنما المحدث: من عرف الأسانيد والعلل، وأسماء الرجال، والعالي والنازل، وحفظ مع ذلك جملة مستكثرة من المتون، وسمع الكتب الستة، ومسند أحمد بن حنبل، وسنن البيهقي، ومعجم الطبراني، وضم إلى هذا القدر ألف جزء من الأجزاء الحديثية، هذا أول درجاته، فإذا سمع ما ذكرناه، وكتب الطباق، ودار على الشيوخ، وتكلم في العلل والوفيات والأسانيد: كان في أول درجات المحدثين، ثم يزيد الله من يشاء مايشاء) انتهى
زهد أهل الصفة
عن الحسن قال بنيت صفة لضعفاء المسلمين فجعل المسلمون يوغلون إليها ما استطاعوا من خير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيهم فيقول: السلام عليكم يا أهل الصفة
فيقولون: وعليك السلام يا رسول الله
فيقول: كيف أصبحتم فيقولون: بخير يا رسول الله
فيقول: أنتم اليوم خير أم يوم يغدى على أحدكم بجفنه ويراح عليه بأخرى ويغدو في حلة ويروح في أخرى فقالوا: نحن يومئذ خير يعطينا الله فنشكر
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنتم اليوم خير.
كانوا نحوا من أربعمائة رجل، وذلك أنهم كانوا يقدمون فقراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لهم أهل ولا مال فبنيت لهم صفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لهم: "أهل الصفة". قال أبو ذر: كنت من أهل الصفة وكنا إذا أمسينا حضرنا باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمر كل رجل فينصرف برجل ويبقى من بقي من أهل الصفة عشرة أو أقل فيؤتى النبي صلى الله عليه وسلم بعشائه ونتعشى معه. فإذا فرغنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ناموا في المسجد". فكانوا فقراء يقعدون في المسجد ما يحرثون ولا يتجرون، ليس لهم كسب ولا مال، إنما هم أضياف الإسلام عند ضيق البلدان، ومع ذلك فإنهم كانوا يحتطبون بالنهار ويسوقون الماء إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرءون القرآن بالليل ويصلون.
وعن فضالة بن عبيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالناس يخر رجال من قيامهم في صلاتهم لما بهم من الخصاصة وهم أهل الصفة حتى يقول الأعراب: إن هؤلاء مجانين.
وقال أكابر الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلّم: اطرد عنك سُقَاط الناس، ومواليهم، وهؤلاء الذين رائحتهم رائحة الضأن، وذلك أنهم كانوا يلبَسون الصوف، حتى نجالسَك ونسمعَ منك.
روى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال: مات رجل من أهل الصفة، وترك دينارين أو درهمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كيتان، صلوا على صاحبكم».
وعن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: مات رجل من أهل الصفة فوجد في مئزره دينار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كية» ثم توفي رجل في مئزره ديناران فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كيتان»
وروى عبد الرزاق وغيره، عن علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تبا للذهب، تبا للفضة» يقولها ثلاثا، فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: فأي مال نتخذ؟ فقال عمر رضي الله عنه: أنا أعلم لكم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله: إن أصحابك قد شق عليهم، وقالوا: فأي المال نتخذ؟ فقال: «لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعين أحدكم على دينه»
وعبادة بن الصامت، أنه علم رجلا من أهل الصفة شيئا من القرآن فأهدى له قوسا فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال «إن أحببت أن تطوق بقوس من نار فاقبله» فتركه، رواه أبو داود
وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لما نزلت (أفمن هذا الحديث تعجبون) قال أهل الصفة: (إنا لله وإنا إليه راجعون) ثم بكوا حتى جرت دموعهم على خدودهم، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بكاءهم بكى معهم فبكينا لبكائه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يلج النار من بكى من خشية الله ولا يدخل الجنة مصر على معصية الله ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيغفر لهم ويرحمهم إنه هو الغفور الرحيم)
عجوز تُبكي سيدنا عمر رضي الله عنه بمدحها للنبي ﷺ
عن زيد بن أسلم قال: خرج أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلةً يحرس، فرأى مصباحًا في بيت، فدنا منه، فإذا عجوز تطرق شَعْرًا لها لتغزله، أي تنفشه بقدح لها، وهي تقول:
عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَاةُ الْأَبْرَارْ ... صَلَّى عَلَيْكَ الْمُصْطَفَوْنَ الْأَخْيَارْ
قَدْ كُنْتَ قَوَّامًا بَكِيَّ الْأَسْحَارْ ... يَا لَيْتَ شِعْرِي وَالْمَنَايَا أَطْوَارْ
هَلْ تَجْمَعُنِي وَحَبِيبِي الدَّارْ
تعني النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس عمر يبكي، فما زال يبكي حتى قرع الباب عليها، فقالت: من هذا؟ قال: «عمر بن الخطاب»، قالت: ما لي ولعمر؟ وما يأتي بعمر هذه الساعة؟ قال: «افتحي رحمك الله، ولا بأس عليك»، ففتحت له: فدخل، فقال: «ردي علي الكلمات التي قلت آنفا»، فردته عليه، فلما بلغت آخره قال: «أسألك أن تدخليني معكما»، قالت: «وعمر، فاغفر له يا غفار»، فرضي عمر ورجع.
[الزهد والرقائق لابن المبارك، والشفا للقاضي عياض]
نماذج من الدس على العلماء
دُسَّ على الشيخ عبد الوهاب الشعراني في الطبقات الكبرى فأوضح ذلك في كتابه لطائف المنن والأخلاق فقال: (ومما مَنَّ الله تبارك وتعالى به عليَّ، صبري على الحسدة والأعداء، لما دسوا في كتبي كلاماً يخالف ظاهر الشريعة، وصاروا يستفتون عليَّ زوراً وبهتاناً، ومكاتبتهم فيَّ لِبابِ السلطان، ونحو ذلك. إِعلم يا أخي أن أول ابتلاء وقع لي في مصر من نحو هذا النوع، أنني لما حججْتُ سنة سبع وأربعين وتسعمائة، زَوَّر عليَّ جماعة مسألة فيها خرق لإِجماع الأئمة الأربعة، وهو أنني أفتيتُ بعض الناس بتقديم الصلاة عن وقتها إِذا كان وراء العبد حاجة، قالوا: وشاع ذلك في الحج، وأرسل بعض الأعداء مكاتبات بذلك إِلى مصر من الجبل، فلما وصلتُ إلى مصر، حصل في مِصْرَ رَجٍّ عظيم، حتى وصل ذلك إِلى إِقليم الغربية والشرقية والصعيد وأكابر الدولة بمصر، فحصل لأصحابي غاية الضرر، فما رجعتُ إِلى مصر إِلا وأجد غالب الناس ينظر إِليَّ شذراً، فقلت: ما بال الناس ؟ فأخبروني بالمكاتبات التي جاءتهم من مكة، فلا يعلم عدد من اغتابني، ولاث بعرضي إِلا الله عز وجل.
ثم إِني لما صنفت كتاب البحر المورود في المواثيق والعهود، وكتب عليه علماء المذاهب الأربعة بمصر، وتسارع الناس لكتابته، فكتبوا منه نحو أربعين نسخة، غار من ذلك الحسدةُ، فاحتالوا على بعض المغفلين من أصحابي، واستعاروا منه نسخته، وكتبوا لهم منها بعض كراريس، ودسوا فيها عقائد زائغة ومسائل خارقة لإِجماع المسلمين، وحكايات وسخريات عن جحا، وابن الراوندي، وسبكوا ذلك في غضون الكتاب في مواضع كثيرة، حتى كأنهم المؤلف، ثم أخذوا تلك الكراريس، وأرسلوها إِلى سوق الكتبِيِّين في يوم السوق، وهو مجمع طلبة العلم، فنظروا في تلك الكراريس، ورأوا اسمي عليها، فاشتراها من لا يخشى الله تعالى، ثم دار بها على علماء جامع الأزهر، ممن كان كتب على الكتاب ومن لم يكتب، فأوقع ذلك فتنة كبيرة، ومكث الناس يلوثون بي في المساجد والأسواق وبيوت الأمراء نحو سنة، وأنا لا أشعر. وانتصر لي الشيخ ناصر الدين اللقاني، وشيخ الإِسلام الحنبلي، والشيخ شهاب الدين بن الجلبي، كل ذلك وأنا لا أشعر، فأرسل لي شخص من المحبين بالجامع الأزهر، وأخبرَني الخبرَ فأرسلت نسختي التي عليها خطوط العلماء، فنظروا فيها، فلم يجدوا فيها شيئاً مما دسه هؤلاء الحسدة، فسبُّوا من فعل ذلك، وهو معروف.
وأعرفُ بعض جماعة من المتهوِّرين، يعتقدون فيَّ السوء إِلى وقتي هذا، وهذا بناء على ما سمعوه أولاً من أُولئك الحسدة، ثم إِن بعض الحسدة، جمع تلك المسائل التي دُسَّت في تلك الكراريس وجعلها عنده، وصار كلما سمع أحداً يكرهني، يقول له: إِن عندي بعض مسائل تتعلق بفلان، فإِن احتجت إِلى شيء منها أطلعتك عليه، ثم صار يعطي بعض المسائل لحاسد بعد حاسد إِلى وقتي هذا، ويستفتون عليَّ وأنا لا أشعر، فلما شعرتُ، أرسلت لجميع علماء الأزهر أنني أنا المقصود بهذه الأسئلة، وهي مفتراة عليَّ، فامتنع العلماء من الكتابة عليها)[كتاب "لطائف المنن والأخلاق" للشعراني ج2. ص190ـ191].
وقد ذكر المؤرخ الكبير عبد الحي بن العماد الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه شذرات الذهب في أخبار من ذهب ترجمة الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى وبعد أن أثنى عليه، وذكر مؤلفاته الكثيرة، وأثنى عليها أيضاً قال فيه (وحسده طوائف فدسوا عليه كلمات يخالف ظاهرها الشرع، وعقائد زائغة، ومسائل تخالف الإِجماع، وأقاموا عليه القيامة، وشنَّعوا وسبُّوا، ورموه بكل عظيمة، فخذلهم الله، وأظهره الله عليهم وكان مواظباً على السنة، ومبالغاً في الورع، مُؤثِراً ذوي الفاقة على نفسه حتى بملبوسه، متحملاً للأذى، موزعاً أوقاته على العبادة ؛ ما بين تصنيفٍ وتسليكٍ وإِفادة.. وكان يُسمَعُ لزاويته دوي كدوي النحل ليلاً ونهاراً، وكان يحيي ليلة الجمعة بالصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولم يزل مقيماً على ذلك، معظَّماً في صدور الصدور، إِلى أن نقله الله تعالى إِلى دار كرامته) ["شذرات الذهب في أخبار من ذهب" للمؤرخ الفقيه الأديب عبد الحي الحنبلي المتوفى سنة 1089هـ. ج8. ص374].
وقال الشعراني رحمه الله تعالى في كتابه اليواقيت والجواهر (وقد دسَّ الزنادقة تحت وسادة الإِمام أحمد بن حنبل في مرض موته، عقائد زائغة، ولولا أن أصحابه يعلمون منه صحة الاعتقاد، لافتتنوا بما وجوده تحت وسادته) [اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشيخ عبد الوهاب الشعراني ج1. ص8].
وكذلك ذكر الشيخ مجد الدين الفيروز أبادي صاحب القاموس في اللغة: أن بعض الملاحدة صنف كتاباً في تنقيص الإِمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وأضافه إِليه، ثم أوصله إِلى الشيخ جمال الدين بن الخياط اليمني، فشنَّع على الشيخ أشد التشنيع، فأرسل إِليه الشيخ مجد الدين يقول له (إِني معتقد في الإِمام أبي حنيفة غاية الاعتقاد، وصنفت في مناقبه كتاباً حافلاً وبالغتُ في تعظيمه إِلى الغاية، فأحرِقْ هذا الكتاب الذي عندك، أو اغسله، فإِنه كذب وافتراء عليَّ) [لطائف المنن والأخلاق للشعراني ج1. ص127].
إلى أن قال الشيخ عبدالقادر عيسى:
وقال أيضاً ـ الإمام الشعراني ـ (وكذلك دسوا عليَّ أنا في كتابي المسمى بالبحر المورود جملةً من العقائد الزائغة، وأشاعوا تلك العقائد في مصر ومكة نحو ثلاث سنين، وأنا بريء منها كما بَيَّنْتُ في خطبة الكتاب لمَّا غيرتها، وكان العلماء كتبوا عليه وأجازوه، فما سكنت الفتنة حتى أرسلت إِليهم النسخة التي عليها خطوطهم) ["اليواقيت والجواهر" ج1. ص8].
من عجائب وأسرار معجزة الإسراء والمعراج
الإسراء والمعراج معجزة عظيمة استهل الحق سبحانه وتعالى ذكرها بالسبحنة فقال: (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى)، واشتملت على عجائب لا تحصى ولا تعد منها:
🔷 أن النبي ﷺ أسري به وعرج بالروح والجسد معًا وليس بالروح فقط، بدليل أن المشركين كذبوه عندما قال لهم إنه أسري به إلى بيت المقدس وعاد في ليلته بينما هم يضربون أكباد الإبل شهرًا ذهابًا وشهرًا إيابًا، وطالبوه بأن يثبت لهم صحة، دعواه فسألوه عن وصف بيت المقدس، وعن حال عير لهم في الطريق إلى مكة، فلو كانت رؤيا منام لما تطلب الأمر منهم كل ذلك الإستنكار. وما حيرهم أن النبي ﷺ وصف لهم بيت المقدس وصفًا دقيقًا لا يصدر إلا عن من سكن القدس مع أن النبي ﷺ لم يسافر إلى القدس إلا في الإسراء، ثم أخبرهم عن العير التي سألوه عنها وأخبرهم أنها ستدخل مكة قبل مغيب الشمس فكان ما قال، وغير ذلك من البراهين الجلية.
🔷 أن الرحلة كانت ليلًا، وفي ليلة مظلمة هي ليلة السابع والعشرين من رجب على قول الجمهور، ولم يركب مركبة فضائية، ولم يكن يلبس بزة رواد الفضاء، ولم يكن معه ﷺ مصباح، فدل على أنه ﷺ بشر خاص من حيث:
▪أنه لا يتأثر بما يتأثر به البشر العام من جراء السرعات الخارقة، والأشعة الحارقة، والغازات الخانقة، فقد كان ينطلق بسرعة تفوق سرعة الضوء ولا تتحملها إلا مخلوقات خاصة كالملائكة والأرواح.
▪أنه يرى في الليل كما يرى في النهار لأن الرحلة كانت في ليلة مظلمة، وفي جوف ذلك الليل البهيم وصف لقومه أدق التفاصيل كالعير التي مر بها في الصحراء، وكصلاته في طيبة دار هجرته، وكصلاته في بيت لحم مهد سيدنا عيسى عليه السلام، وكصلاته بالأنبياء في بيت المقدس، وغيرها من عجائب الأحداث.
▪أنه يرى تحت الأرض فقد قال ﷺ: (مررت ليلة أسري بي على أخي موسى قائمًا يصلي في قبره)، ولا عجب، فقد قال صلى الله عليه وسلم: (إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون)، وثبت أنه ﷺ يرى من خلفه كما يرى من أمامه، وأنه لا يخفى عليه خشوع الصحابة من خلفه في الصلاة، والخشوع مكانه القلب، فمن كان لا يخفى عليه ما في القلوب فإن ما في باطن الأرض أهون عليه.
🔷 المسافة التي قطعها النبي ﷺ في الإسراء والمعراج مهولة جدًا، فقد أسري به ﷺ إلى بيت المقدس الذي يبعد عن مكة المكرمة مسافة 1,249 كيلومترًا، ومن ثم عُرج به إلى ما فوق سبع سماوات لمستوى يسمع فيه صريف الأقلام وأبعد من ذلك، مع العلم بأن الضوء الذي تبلغ سرعته 300 ألف كيلومتر في الثانية يحتاج إلى 8 مليار سنة ليقطع المسافة من الأرض إلى حدود السماء الدنيا! وسمك كل سماء، والمسافة بين كل سماء وسماء تعدل المسافة بين السماء والأرض، فتخيل المسافة المهولة التي قطعها رسول الله ﷺ في هذه الرحلة العجيبة، وقد أسري به ﷺ وعرج وفراشه الشريف لم يفقد دفئه، أي أن الرحلة مع كل تلك التفاصيل كانت كطرفة عين، وفي هذا إشارة إلى معانٍ قريبة من النظرية النسبية.
🔷 أن الله عز وجل كشف الحجاب الأعظم لحبيبه المصطفى ﷺ، وتجلى له فرآه، وليس لأحد سواه أن يرى الله تبارك وتعالى في الدنيا. قال رسول الله ﷺ: "رأيت ربي عز وجل" أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح، وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن النبي ﷺ رأى ربه بعينه، وأخرج النسائي، والحاكم وصححه، وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "أتعجبون أن تكون الخُلة لإبراهيم، والكلام لموسى، والرؤية لمحمد ﷺ؟ِ"، وعن أنس رضي الله عنه قال: "أن محمدًا ﷺ رأى ربه عز وجل"، وروى الخلال في كتاب السنة عن المروزي قلت للإمام أحمد بن حنبل إنهم يقولون إن عائشة قالت من زعم أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية فبأي شيء يدفع قولها؟ قال بقول النبي ﷺ "رأيت ربي"، وقول النبي ﷺ أكبر من قولها، وكان الإمام أحمد ممن يثبت الرؤية.
🔷 التجلي يعني الظهور، فالله عز وجل يتجلى أي يظهر حيث يشاء كما قال تعالى: (فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا)، لكنه تبارك وتعالى تنزَّه عن أن يحل في مكان لأن الحلول من صفات المخلوقين، والخالق ليس كمثله شيء. وخير مثال لتقريب معنى التجلي هو ظهور شخص على شاشة التلفاز، فإنك لو فتحت التلفاز من الداخل فإنك لن تجد بداخله ذلك الشخص لأن الأمر مجرد ظهور لا حلول، ومثال آخر أنك لو نظرت في المرآة فستظهر صورتك فيها، لكنك لو ذهبت ونظرت وراءها فلن تجد نفسك هناك، فالأمر ظهور.
🔷 أن للنبي ﷺ له علم خاص لا يعلمه أحد غيره من الخلق، فعندما أوحى الله تبارك وتعالى إلى عبده سيدنا محمد ﷺ (فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ) لم يكن معه أحد، وفرضت عليه الصلوات الخمس وليس معه أحد، وأعطي خواتيم سورة البقرة قبل أن ينزل بها جبريل عليه السلام، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "لما بلغ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ سدرةَ المنتهى أعطاه اللهُ عندَها ثلاثًا لم يُعطِهنَّ نبيًّا كان قبلَه:فُرِضت عليه الصلاةُ خمسًا، وأُعطِيَ خواتيمَ سورةِ البقرةِ، وغُفِر لأمَّتِه المُقْحِماتِ ما لم يشركوا باللهِ شيئًا" أخرجه مسلم
🔷 أنه مر بسيدنا موسى عليه السلام قائمًا يصلي في قبره، وصلى به في بيت المقدس، والتقاه في السماء السادسة، ما يدل على تعدد وجود الذوات الشريفة بقدرة الله تبارك وتعالى حيثما شاء وكيفما شاء.
🔷 أن موسى عليه السلام شفع للأمة لدى رسول الله ﷺ حتى خففت الصلاة من خمسين إلى خمس وبأجر الخمسين، وفيه إشارة إلى أن الميت ينفع بإذن الله تعالى، فعندما عرج بالنبي ﷺ كان سيدنا موسى عليه السلام من الأموات.
🔷 أن النبي ﷺ سافر عبر الزمن إلى يوم القيامة وحكى من مشاهد القيامة العجائب، فقال ﷺ: "لما عرج بي ربي عز وجل مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم"، وقال ﷺ: "رأيت ليلة أسري بي رجالاً تقرض شفاههم بمقارض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون"
الصحابة من الجن
الفترة بين انتقال النبي صلى الله عليه وسلم وبيننا ليست كبيرة بالنظر إلى أعمار الجن، هي فقط 1,428 عامًا، أعمار الجن طويلة جدًا فهذه الفترة قصيرة، فبالنظر إلى عمر إبليس لعنه الله، أو عمر أبنائه المنظرين، نجد أن أعمارهم طويلة جدًا، ومن كان دون المنظرين كانت أعماره طويلة كذلك، فالصحابي هامة بن الهيم على سبيل المثال عندما لقي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره ثمانية آلاف وأربعمائة واثنان وعشرون سنة!!! لذلك هناك لم يزل صحابة من الجن بين ظهرانينا ونحن في هذا الزمان والحمد لله عز وجل، لأن الصحابة من الجن الذين صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا سبعة وثلاثون ألفًا، ففي رواية عن سيدنا عمر رضي الله عنه زاد فيه انه قال: (أتى عليَّ ثمانية آلاف وأربعمائة واثنتان وعشرون سنة وانه كان يوم قتل قابيل هابيل غلاما وان عدد الجن الذين استمعوا القرآن وصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلّم ثلاثة وسبعون ألفا). والصحابي هامة بن الهيم بن لاقيس بن إبليس، ليس بينه وبين إبليس إلا أبوان فقط وعاش بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم، أورده الحافظ بن حجر في الصحابة في كتابه الإصابة، وورد خبره من عدة طرق يبلغ بها درجة الحسن، فقد أخرجه عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل في زيادات الزهد، والفاكهي في أخبار مكة، وابن مردويه في التفسير، والبيهقيّ في الشّعب، وجعفر المستغفريّ في معرفة الصحابة، وتابع عليه ابن عساكر من طريق محمد بن أبي معشر، وأخرج أبو موسى في الذّيل طرقًا أخرى. وقد ترجم الحافظ ابن حجر لأكثر من 22 صحابيًا من الجن في كتابه الإصابة.
بعض الاثار في الصحابة من الجن:
عن أنس بن مالك، قَالَ: كنت مع النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خارجًا من جبال مكة، إِذْ أقبل شيخ متكيء عَلَى عكازة، فقال النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مشية جِنِّي ونَغمَته " قَالَ: أجل، قَالَ: " من أي الجن أنت؟ " قَالَ: أنا هامة بن الهيم بن لاقيس بن إبليس، قَالَ: "لا أرى بينك وبينه إلا أبوين"، قَالَ: أجل، قَالَ: "كم أتى عليك؟" قَالَ: أكلتُ عمر الدُّنْيَا إلا أقلها، كنت ليالي قتل قابيل هابيل غلامًا ابن أعوام، وذكر أَنَّهُ تاب عَلَى يد نوح عَلَيْهِ السلام، وآمن معه، وأنه لقي شعيبًا عليه السلام، وإبراهيم الخليل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى نبينا مُحَمَّد الصلاة والسلام، ولقي عيسى عَلَيْهِ السلام، فقال لَهُ عيسى: إن لقيت مُحَمَّدًا فأقرئه مني السلام، وقد بلغت وآمنت بك، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عَلَى عيسى السلام، وعليك يا هامة "، وعلمه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عشر سور من القرآن، فقال عمر بن الخطاب: فمات رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم ينعه لنا، ولا أراه إلا حيا".
وأخرجه جعفر المستغفري وإسحاق بن إبراهيم المنجنيقي عن سعيد بن المسيّب، قال: قال عمر... فذكره مطولًا؛ وزاد فيه: إنه قال: "أتى علي ثمانية آلاف وأربعمائة واثنتان وعشرون سنة، وإنه كان يوم قَتلَ قابيلُ هابيلَ غلامًا، وإنّ عدد الجِنّ الذين استمعوا القرآنَ وصلُّوا خلفَ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم ثلاثة وسبعون ألفًا"
وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم في دار الأرقم مختفيا في أربعين رجلًا وبضع عشرة امرأة، فدُقّ الباب، فقال: «افتحوا، إنّها لنغمة شيطان» قال:
ففتح له، فدخل رجل قصير، فقال: السلام عليك يا نبي اللَّه ورحمة اللَّه وبركاته. فقال:
«وعليك السّلام ورحمة اللَّه، من أنت»؟ قال: أنا هامة بن الهيم بن لاقيس بن إبليس، قال:
«فلا أرى بينك وبين إبليس إلّا اثنين» قال: نعم. قال: «فمثل من أنت يوم قتل قابيل هابيل»؟ قال: أنا يومئذ غلام يا رسول اللَّه، قد علوتُ الآكام، وأمرتُ بالآثام، وإفساد الطّعام، وقطيعة الأرحام. قال: بئس الشيخ المتوسّم، والشّاب الناشئ! قال: لا تقل ذاك يا رسول اللَّه، فإنّي كنت مع نوح وأسلمت معه، ثم لم أزل معه حتى دعا على قومه فهلكوا فبكى عليهم وأبكاني معه، ثم لم أزل معه حتى هلك، ثم لم أزل مع الأنبياء نبيّا نبيا، كلهم هلك حتى كنت مع عيسى ابن مريم فرفعه اللَّه إليه، وقال لي: إن لقيت محمدا فأقرئه مني السلام، فقال النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم: «وعليه السّلام ورحمة اللَّه وبركاته، وعليك السّلام يا هامة»
أما الجني سُرَّق الذي ورد في قصة مع سيدنا عمر بن عبد العزيز، فإنه لم يكن آخر الصحابة من الجن بل كان ضمن آخر اثنين بقيا من سبعة أو تسعة من الجن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في وادٍ في الطريق إلى مكة المكرمة يقال له وادي نخلة، وهم أشراف الجن من نصيبين، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الجن سبعة نفر من جن نصيبين فجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم رسلا إلى قومهم. وقال زر بن حبيش: كانوا تسعة أحدهم زوبعة. وقال قتادة: إنهم من أهل نينوى. وقال مجاهد: من أهل حران. وقال عكرمة: من جزيرة الموصل. وقيل: إنهم كانوا سبعة، ثلاثة من أهل نجران وأربعة من أهل نصيبين. ويروى أن الله عز وجل صرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من الجن من نينوى وجمعهم له كما قال تعالى: (وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين)، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إني أريد أن أقرأ القرآن على الجن الليلة فأيكم يتبعني؟" فأطرقوا، ثم قال الثانية فأطرقوا، ثم قال الثالثة فأطرقوا، فقال ابن مسعود: "أنا يا رسول الله"، قال ابن مسعود: "ولم يحضر معه أحد غيري، فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة دخل النبي صلى الله عليه وسلم شِعبا يقال له (شِعب الحجون) وخط لي خطًا وأمرني أن أجلس فيه" وقال: "لا تخرج منه حتى أعود إليك". ثم انطلق حتى قام فافتتح القرآن، فجعلت أرى أمثال النسور تهوي وتمشي في رفرفها، وسمعت لغطًا وغمغة حتى خفت على النبي صلى الله عليه وسلم، وغشيته أسودة كثيرة حالت بيني وبينه حتى ما أسمع صوته، ثم طفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين، ففرغ النبي صلى الله عليه وسلم مع الفجر فقال: "أنمت؟" قلت: "لا والله، ولقد هممت مرارًا أن أستغيث بالناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك تقول اجلسوا"، فقال: "لو خرجت لم آمن عليك أن يخطفك بعضهم" ثم قال: "هل رأيت شيئا؟" قلت: "نعم يا رسول الله، رأيت رجالًا سودًا مستثفري -جمعوا أطراف ثيابهم وأخذوها من بين فخذيهم وربطوها في وسطهم- ثيابا بيضا، فقال: "أولئك جن نصيبين سألوني المتاع والزاد فمتعتهم بكل عظمٍ حائلٍ، وروثة وبعرة"، فقالوا: يا رسول الله يقذرها الناس علينا. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بالعظم والروث. قلت: "يا نبي الله، وما يغني ذلك عنهم!" قال: "إنهم لا يجدون عظمًا إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكل، ولا روثة إلا وجدوا فيها حبَّها يوم أكل" فقلت: "يا رسول الله، لقد سمعت لغطًا شديدًا؟" فقال: "إن الجن تدارأت -اختلفت وتخاصمت- في قتيل بينهم فتحاكموا إلي فقضيت بينهم بالحق.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمشون فرفع لهم إعصار ثم جاء إعصار أعظم منه فإذا حية قتيل، فعمد رجل منا إلى ردائه فشقه وكفن الحية ببعضه ودفنها، فلما جن الليل إذا امرأتان تسألان: أيكم دفن عمرو بن جابر؟ فقلنا: ما ندري من عمرو بن جابر! فقالتا: إن كنتم ابتغيتم الأجر فقد وجدتموه، إن فسقة الجن اقتتلوا مع المؤمنين فقتل عمرو، وهو الحية التي رأيتم، وهو من النفر الذين استمعوا القرآن من محمد صلى الله عليه وسلم ثم ولوا إلى قومهم منذرين. وذكر ابن أبي الدنيا عن رجل من التابعين سماه: أن حية دخلت عليه في خبائه تلهث عطشا فسقاها ثم أنها ماتت فدفنها، فأتي من الليل فسلم عليه وشكر، وأخبر أن تلك الحية كانت رجلا عن جن نصيبين اسمه زوبعة. وقد قتلت السيدة عائشة رضي الله عنها حية رأتها في حجرتها تستمع وعائشة تقرأ، فأتيت في المنام فقيل لها: إنك قتلت رجلًا مؤمنًا من الجن الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لو كان مؤمنًا ما دخل على حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها: ما دخل عليك إلا وأنت متقنعة، وما جاء إلا ليستمع الذكر. فأصبحت عائشة فزعة، واشترت رقابًا فأعتقتهم.
فقد أخرج البيهقي وحسّنه قال: بينما عمر بن عبد العزيز يمشي إلى مكة إذ رأى حية ميتة فدفنها، فإذا هاتف يهتف: رحمة الله عليك يا سُرَّق! فقال عمر: من أنت؟ قال: أنا رجل من الجن وهذا سُرَّق،لم يبق ممن بايع رسولَ الله غيري وغيرَه، وأشهد لسمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول:(تموت يا سُرَّق بفلاة من الأرض و يدفنك خير أمتي -يعني في زمانه)، فحلّفه عمر على ذلك فحلف له فبكى عمر.
وأخرج الحافظ ابن حجر في الإصابة بسنده عن العباس بن أبي راشد، عن أبيه قال: نزل بنا عمر بن عبد العزيز، فلما رحل قال لي مولاي: اركب معه فشيّعه. قال: فركبت فمررنا بواد، فإذا نحن بحية ميتة مطروحة على الطريق، فنزل عمر فنحّاها وواراها، ثم ركب، فبينا نحن نسير إذا هاتف يهتف، وهو يقول: يا خرقاء! يا خرقاء! فالتفتنا يمينا وشمالا فلم نر أحدا. فقال له عمر:
أنشدك اللَّه أيها الهاتف، إن كنت ممن يظهر إلّا ظهرت لنا، وإن كنت ممن لم يظهر أخبرنا عن الخرقاء. قال: هي الحية التي لقيتم بمكان كذا وكذا، فإنّي سمعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يقول لها يوما: يا خرقاء، «تموتين بفلاة من الأرض، يدفنك خير مؤمن من أهل الأرض»
فقال له عمر: أنت سمعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يقول هذا؟ فتعجب عمر وانصرفنا.
وفي رواية:
بينما عمر بن عبد العزيز يمشي إلى مكة بفلاة من الأرض إذ رأى حية ميتة، فقال: علي بمحفار.
فقالوا: نكفيك أصلحك الله.
قال: لا ثم أخذه ثم لفه في خرقة ودفنه، فإذا هاتف يهتف رحمة الله عليك يا سُرَّق.
فقال له عمر بن عبد العزيز: من أنت يرحمك الله ؟
قال: أنا رجل من الجن، وهذا سُرَّق ولم يبق ممن بايع رسول الله ﷺ غيري وغيره وأشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول: « تموت يا سُرَّق بفلاة من الأرض ويدفنك خير أمتي ».
وفي رواية: "قال: أنا من السبعة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا الوادي وإني سمعته يقول لهذه الحية: (لتموتن بفلاة من الأرض وليدفننك خير أهل الأرض يومئذ) فبكى عمر حتى كاد أن يسقط عن راحلته وقال: يا راشد أنشدك الله أن تخبر بهذا أحدًا حتى يواريني التراب"
قيل اسمها خرقاء، وقيل وصف لها، قال أبو نعيم في آخر ترجمة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه وجد حيّته ميتة فلفّها في خرقة فدفنها، فسمع قائلا يقول: هذه خرقاء.
أخرجه أبو نعيم في الحلية والآجري في أخبار عمر بن عبد العزيز والبيهقي في الدلائل
الذبيح هو سيدنا إسماعيل عليه السلام
بشر الله تبارك وتعالى سيدنا إبراهيم عليه السلام بغلام حليم وهو سيدنا إسماعيل عليه السلام، (فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ)[سورة الصافات 101]
وبغلام عليم وهو سيدنا إسحاق عليه السلام، (قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ) [سورة الحجر 53]، (فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ)[سورة الذاريات 28]
وكان إسماعيل عليه السلام هو البكر، ولد وكان عمر سيدنا إبراهيم كبيرا، قيل كان عمره ست وثمانون سنة، ثم ولد سيدنا إسحاق عليه السلام لاحقا وعمر سيدنا إبراهيم تسع وتسعون سنة، (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ)[سورة إبراهيم 39].
والذبيح هو سيدنا إسماعيل عليه السلام لأنه كان هو البكر الوحيد عندما أمر سيدنا إبراهيم عليه السلام بذبحه، وهنا البلاء المبين. يظهر هذا صريحًا في سياق الآيات التي صورت الحادثة، وبعد ذكرها تحدثت الآيات عن ميلاد سيدنا إسحاق عليه السلام في تسلسل زماني عجيب، فقال الحق سبحانه:
(وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ * رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ * فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ * فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ * فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ * وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ * وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ * وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ * سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ * كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ * وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ * وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ ۚ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ)[سورة الصافات 99 - 113]
ومع كل ذلك زعم اليهود حسدا أن الذبيح هو سيدنا إسحاق عليه السلام، وأخذ عنهم بعض المسلمين هذا الزعم وهو باطل، لأن الملائكة بشرت السيدة سارة عليها السلام في حضرة زوجها سيدنا إبراهيم عليه السلام بإسحاق ومن ورائه يعقوب!!! أي أن سيدنا اسحاق عليه السلام لن يموت قبل أن ينجب سيدنا يعقوب فكيف يؤمر سيدنا إبراهيم عليه السلام بذبحه مع وعد الله عز وجل الذي لا يخلف الميعاد، فليس هنا بلاء مبين لأن النتيجة معروفة أنه لن يموت. وإنما البلاء في ذبح البكر الوحيد على الكبر، ومشاورة الولد على الذبح، وموافقته على ذلك وأنه سيكون من الصابرين، فهذا مقام الحلم الذي يليق بسيدنا إسماعيل عليه السلام (فبشرناه بغلام حليم).
زد الى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (أنا ابن الذبيحين) الذي حسنه الحافظ في فتح الباري، ولما رواه الطبري والحاكم بسند صحيح عن الصنابحي قال حضرنا مجلس معاوية بن أبي سفيان فتذاكر القوم اسماعيل واسحاق ابني ابراهيم عليهم الصلاة والسلام فقال بعضهم: الذبيح اسماعيل وقال بعضهم بل اسحاق فقال معاوية: سقطتم على الخبير كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي يشكو جدب أرضه؛ يا رسول الله خلفت البلاد يابسة والماء يابسا هلك المال وضاع العيال فعد علي مما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. فقلنا لمعاوية من الذبيحان يا أمير المؤمنين: فقال ان عبدالمطلب لما أمر بحفر زمزم نذر لله أن سهل له أمرها أن ينحر بعض ولده فأخرجهم وأسهم بينهم فخرج السهم لعبد الله فأراد ذبحه فمنه أخواله من بني مخزوم وقالوا له ارض ربك وافد ابنك ففداه بمائة ناقة فهو الذبيح واسماعيل الثاني.
هل عندكم يا اخوان من مزيد؟
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)